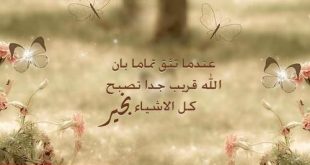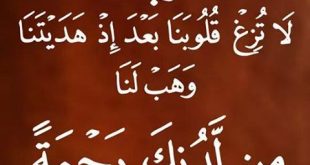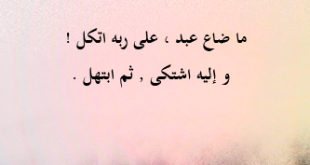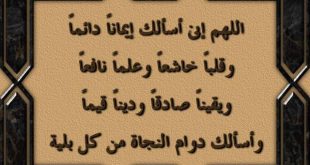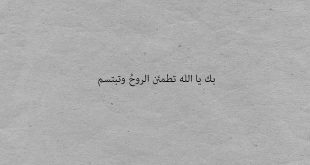فى الفكر العربى و ظاهره الدينلقد اثر الدين فالمعرفه و البحث فالمجتمع العربى من حيث اختيار النظريات و المناهج و الميادين. و وضع الحدود التي لا تتعارض مع تعاليم الدين و روحه. و فكره العلم النافع و غير النافع التي ترد فالتراث كثيرا تعبر عن تدخل الدين او توجيهة المعرفه المطلوبه حتي تاتى ملبيه الاشياء المجتمعيه و الفكرية، و لكى تحافظ علي الوحده و التماسك فعديد من الاحوال. و ربما كانت كلمه العلم و العلماء، و ما زالت _فى بعض الحالات _ ترتبط بالمعارف الدينيه و اهلها. اما الظاهره الدينية، الموضوع، فقد ظلت خارج ميدان الدراسه العلميه لانها تتضمن فوق البشرى و المتعالي. و تنتهى حدود اي دراسه عن الدين عند الشرح او التاويل الذي ممكن الدين من مسايره مستجدات التاريخ و التطور.اخذت دراسه الظاهره الدينيه حيزا كبيرا فالفكر العربى _ الاسلامى المعاصر، و لكن علم الاجتماع فالوطن العربى بتعريفة و محاولاتة المعروفه فالجامعات و المؤسسات الاكاديميه و البحثيه لم يساهم بقدر و اف فدراسه الظاهره الدينيه بوسائلة و تحليلاتة الخاصه رغم اهميه الظاهرة.ايضا نعنى بالتفسير الاجتماعى _ التاريخى للظاهره الدينيه الاجابه عن نشاه الدين و وظائفة و توظيفه، بتتبع التطور الزمنى و السياق الاجتماعى و الثقافى للظاهرة. و نستطيع القول، بحسب الفهم المعروف لعلم الاجتماع و المقصود من الدراسه الاجتماعيه للدين، ان الميدان فكليتة ما زال بعيدا عن البحث و التناول رغم و جود دراسات عديده بالذات الفلسفيه و الفكريه و السياسيه فالفتره الاخيره جاءت تبحث فعجله عن الواقع الذي تنامت ضمنة الاتجاهات و التيارات الدينية.هذا قصور فعلم الاجتماع العربي، و شكل من ملامح ازمتة الراهنة، اذ يفتقد التحليل السوسيولوجى ظاهره البعد التاريخى و الوعاء الاجتماعى الذي تتفاعل و تنمو الظاهره داخله، و تعالج غالبا كمقال لا تاريخي، مجرد خارج المجتمع. و دراسه الظاهره الدينيه اجتماعيا مثال ساطع علي ذلك التناول الناقص الذي لا يتعرض للتاثير المتبادل بين الدين و بقيه الظواهر الاجتماعيه و المجتمع الكلي.يمكن ان نعيد سبب انتشار ذلك التناول التناقصى الي ظهور منهج او دعوه الي منهج يتضمن العقيده او الايديولوجيا الدينيه كجزء اساسي. و ذلك يجعل من الدراسه الموضوعيه للدين امرا مستحيلا اذ يصبح الباحث ملاحظا مندمجا و ليس مجرد مشارك فالظاهرة، و بالتالي تاتى النتائج و الفرضيات تعبيرا ذاتيا. هنالك دعوه تجد قبولا و انتشارا فالاوساط العلميه تطالب بمنهج يبدا بالاقرار بحقيقه المفهوم المحورى فالايديولوجيا السائدة، ايديولوجيا الحضاره الاسلامية، و المفهوم المحورى عندها هو الايمان بالله الواحد الخالق. و يعتبر ذلك الاتجاة ان التسليم بتلك الحقيقه مهم لانة يلعب الدور نفسة الذي لعبتة الايديولوجيا الغربيه المضاده (الدنيوية) التي و ضعت الانسان فمركز المجتمع و الكون بدلا من الله تعالي و فق عقيده التوحيد الاسلامية. و رغم ان ذلك الاتجاة يقر بان الصيغه الاسلاميه هذة بها ميتافيزيقيا لا علمية، الا انه يري عدم تناقضها مع العقلانية. و هنا المفترق، فالعلم و من هذا علم الاجتماع، لا يدرس الميتافيزيقيا، كما ان للايديولوجيا الدينيه طرائقها و منهجها و لغتها الخاصه فتحليل الظواهر التي تختلف عن ادوات علم الاجتماع، مثلا.يصل المنهج السابق باصحابة الي القول: ان المجتمع الاسلامى يتميز عن جميع المجتمعات البشريه الاخري و لا يخضع لما تخضع له من قوانين و تطور، و كهذا الفهم يرفع المجتمع الاسلامي، و بالتالي ظواهرة جميعا، عن مستوي البحث الانساني. و يقول احد الكتاب حرفيا: ان المجتمع فالاسلام انما ينبثق من التلازم الوثيق بين التصور الاعتقادى و طبيعه النظام الاجتماعي… هذا التلازم الذي لا ينفصل و لا يتعلق بملابسات العصر و البيئة… يتميز المجتمع الاسلامى عن المجتمعات الاخري التي نشات و فق مقتضيات ارضيه و نتيجه صراع داخلي، و مصالح متعارضة… و لذلك فليس يندرج تحت تاريخ التطور الاجتماعى و لا تصدق علية القوانين الاجتماعيه التي تصدق علي اوروبا. فهو مجتمع شريعه كاملة. و لا يقتصر ذلك التعالى علي دراسه الظاهره الدينية، و لكن جميع ظواهر المجتمع الاسلامى من سياسيه و اقتصاديه و غيرها لا تصدق عليها قوانين اوروبا، ليس لانها اوروبيه و خاصة، و لكن لان المجتمع الاسلامى ذو طبيعه مختلفه اساسا عن بقيه المجتمعات و ظواهرة كامله و سرمدية.يسعي البعض الي حل الاشكاليه بين العلم و الدين فمجال علم الاجتماع بمحاوله ايجاد علم اجتماع انسانى _ الهي، و هذا لان العلوم الاجتماعيه فالغرب، الاشتراكيه منها او الليبرالية، مبنيه علي “تجاهل حقوق الله و حقوق الانسان الكامله بجميع ابعادها الروحيه و من شانها ان تسبب عند دخولها فمجتمع تقليدى لا يزال مبنيا علي القيم الدينيه و الاخلاقيه اهتزازا و اضطرابا و فقدان توازن، الامر الذي يحدث فالمجتمع انقساما يسبب عند الجماهير غير المتنوره رد فعل عنيف يلقى فيها فاحضان المتطرفين، فيجعلها تتشبث بتقاليد لا تمت الي الدين الحقيقى بصلة”. و ينفى كهذا الطرح عن علم الاجتماع علميتة و كان مهمتة جعل الجماهير تختار شكلا معينا من التدين. بعدها لا يقترح الكيفية العمليه و المنهجيه التي تمكن من تاسيس علم اجتماع انسانى _ الهي، و يقترح علي العالم الاجتماعى ان يستفيد من التراث الاسلامى لمحاوله دراسه الشخصيه مع ضروره تنقيه ذلك التراث و تمييز “ما هو ديني صرف و ما هو فارسى او تركى او مصرى او فولكلورى الخ…”. ليست هذة مهمه الاجتماعي، و لكنها مهمه رجل الدين او الفقهاء. و ذلك يدل علي استحاله قيام كهذا العالم الالهى _ الانساني. و فالفلسفه دعوه مماثله تحاول التوفيق بين الوحى و العقل. و تكتسب هذة الدعوه تاييدا و اسعا تحت اسم تكامل “الوحى و العقل” بهدف معالجه الازمه الفكريه التي يواجهها المجتمع العربى _ الاسلامى و هى تتخذ ابعادا متعدده اهمها “الغزو و التبديل الثقافى فمجال العلوم الانسانيه و الاجتماعيه بخاصة، هذا التبديل الذي جعل عقول ابناء الامه الاسلاميه تتخطي الفكر الاسلامى و التراث الاسلامى او تدرسة علي انه ظواهر ربما اندثرت لا علاقه لها بالحياة المعاصره و لا حاجه اليها”. اما تكامل الوحى و العقل فيقوم علي افتراض خطير يحرم العلم من اداه مهمه و هى العقل، فرغم الاعتراف بدورة الا ان اصحاب ذلك الاتجاة يقولون: “فالعقل الانسانى رغم جميع مكانتة و امكاناتة فحياة البشر _يظل محدودا جزئيا يعتمد الاستقراء و تراكمات المعرفه و الخبره لادراك مسيرتة و سبل ادائه. و جاء الوحى علي ايدى المعصومين الصادقين من الانبياء و الرسل ليمد العقل الانسانى بالمدركات الكليه فعلاقات الكون و موضع الانسان منها و مهمه و جودة تجاهها و قواعد علاقاتة الانسانيه و الاجتماعيه الاساسيه اللازمه لترشيد سعية و تحقيق غايه و جوده”.2_ حاضر دراسه الدين و افقها اجتماعياظهر تياران فالعقدين الماضيين احدهما يبحث عن تفسير ايجابى للدين و يشترك فية باحثون من غير الاجتماعيين _ بالمعني الحصرى _ و يتضمن هذا الكتابه عن دور الدين فالتغيير الاجتماعى او التنمية، او فالضبط الاجتماعي. و ممكن ادراج كتابات “التراث و المعاصرة” و “الاصل و العصر” و “التجدد الذاتي” و “الهويه او الذاتيه و الاخر” ضمن ذلك التيار. و تسعي هذة الفئه الي ايجاد اسس مشتركه بين الواقع المتغير و النصوص، او التوفيق بين رؤيه / عقيده و واقع. و اهتم التيار الثاني بما يسمي الصحوه الاسلاميه او الاحياء الديني، او الحركات الدينيه او الجماعات الاسلاميه المتطرفة. و تتسم كهذة الدراسات بطابع سياسى و اعلامى يلاحق الاحداث الانية، فهى فالواقع تنقب عن الدور السياسى _ تقدما او تراجعا _ للدين و بالذات الاسلام، و ذلك و ليد تحولات ايران بعد الشاة و تعاظم نفوذ الدول النفطيه _ الاسلاموية، و هى كتابات انطباعيه فالغالب.يفتقد التياران النظريه الاجتماعيه فتفسير الدين او الحركات الدينيه او الادوار الدينية. و عندما تبحث الكتابات عن نظرية، فهى لا تتعدي دوركايم، تنتقى منة المقولات و الفرضيات التي تودها، و تبتعد كلها عن معالجه الدين كنظام للمعني (Meaning System) يؤسسة الانسان، او بالاصح، المجتمع ليعطى اطارا شاملا للفعل و الفهم الانسانيين. حتي بالنسبه الي النموذج الدوركايمى فهو صالح فحال تعديله، بحيث يستوعب حقيقه ان الديناميه الداخليه محكومه بقوي و علاقات الانتاج اكثر من العوامل الديمغرافيه كنسب الاكل الي السكان. اضافه الي تعديل المنحي المثالى الذي يركز علي الاستجواب الايديولوجى عما هو الخير و الحق (القيم)، ليعطى اعتبارا اكثر استجواب ما هو الادراك (Cognition) و ما هو الممكن او الخيال (Imagination). و ذلك تركيب للمنظور السوسيولوجى مع الماديه التاريخية. و هنالك نقاط التقاء كثيره بينهما، بالذات التطور التاريخى للظواهر بما بها الافكار و عملها فعلاقات بالظواهر الاخرى.نجد خارج التيارين السابقين كتابات حاولت ان تتخذ شكلا نقديا فالتعامل مع الظاهره الدينية، و لكن اغلب هذة الكتابات كانت معارك فكريه و كانها حوار عقول مع عقول، و لا تهتم كثيرا بالاصول الاجتماعية. و ربما انتجت الفتره التي اعقبت حرب حزيران/ يونيو 1967 اعدادا من هذة الكتابات ابرزها كتاب صادق جلال العظم: نقد الفكر الدينى و ربما اثار ضجه كبيره لدي صدوره. و هدف الكتاب كما حددة مؤلفه، هو التصدى “بالنقد العلمى و المناقشه العلمانيه و المراجعه العصريه لبعض نواحى الفكر الدينى السائد حاليا بصورة المختلفه و المتعدده فالوطن العربي”، و الكتاب لا يخلو من اشارات الي ان الفكر الغيبى هو تعبير عن الاوضاع الاقتصاديه و علاقات الطبقات المختلفة. و من الملاحظ ان المهتمين بالفلسفه و قضايا الفكر و الثقافه هم الذين حملوا عبء الكتابه عن الدين. و لكن يهمنا _رغم تقديرنا لتلك المساهمات القيمه _ التعرف الي الكتابات الاجتماعيه التي تطرح اسئله مثل: لماذا ساد كهذا النوع من الفكر او الحركه الدينيه فهذا الوقت بالذات و داخل ذلك المجتمع بعينه.3_ هل من الممكن دراسه الاسلام اجتماعيا؟يواجة المنهج الاجتماعى _ التاريخ فدراسه الدين اشكاليه العلاقه بين المتعالى او فوق الطبيعى او فوق البشرى و بين المجتمع المادى او الطبيعى او البشري. و فحاله الاسلام بين النص المقدس (القران الكريم و السنة) و بين ضرورات الحياة العاديه و ظروفها. و يعطى قول الشهرستاني: “ان النصوص متناهيه و ان الوقائع غير متناهيه و ان المتناهى لا يحكم غير المتناهي” اشاره الي امكانيه غلبه الواقع علي النص. و لكن علي كهذا القول ان يواجة مساله القول بصلاحيه النصوص لكل زمان و مكان. و هذة مهمه اي دراسه اجتماعيه للظاهره الدينية، اي البحث عن علاقه النصوص المقدسه بالواقع؛ و ذلك مدخل يسهل المهمه بتضييق الفجوه بين المطلق و النسبي. و يؤكد احد المفكرين الدينيين المستنيرين و جود علاقه عضويه بين الفكر و الواقع، و يري ان سبب نزول الايات دليل علي و جود مشكله او موقف و اقعى محدد جاءت الايات بشرحة و بيان طريقة التصرف فيه. ايضا يثبت التدرج فالنزول، و النسخ اضافه الي اللغه و الامثال المستعملة، و جود علاقه بين القران و الواقع المعاش. و لكن عالم الاجتماع لابد له من منهج دينامى متغير، و عندما يحلل الدين من منظور اجتماعى فهو ليس مطالبا ب “التركيز علي النصوص المجرده او علي التعاليم الدينيه بحد ذاتها بل علي السلوك الدينى فالحياة اليوميه و فمحتواة الاجتماعى التاريخى ضمن اطار الصراعات القائمه فالمجتمع”؛ لذا فانة اذا كان الاسلام يخرج و احدا كما تبرزة نصوص القران و السنة، فان الممارسات التاريخيه و الاجتماعيه لهذا الاسلام تتعدد و تختلف معتمده علي تفسيرها الخاص للنصوص لتسند موقفها و تعطية مشروعيه خاصة.بوسع الباحث ان يمسك بعديد من الخيوط التي تثبت اجتماعيه الظاهره الدينية، و لكن اغلب هذة المساهمات جاءت من مؤرخين. و من هذة التفسيرات الدراسات الخاصه بظهور الفرق و المذاهب الفكريه ضمن الاسلام. فهذا يؤكد ان الاسلام تاويل و قراءات تختلف بحسب القوي و الفئات الاجتماعيه التي تساند فهما بعينه. و من التبسيط ارجاع الاختلافات الي اراء اسلاميه فحسب، و لكنها مواقف سياسيه _ اجتماعيه تتقنع بوجوة اسلامية. فجماعات كالخوارج و الشيعه و المعتزله لا تفهم بحسب التحليل السياسى او الفكرى فقط، و بالتالي البحث عن موقعها المجرد من السلطة، او البحث عن اصول فكرها و التاثيرات التي تعرضت لها. فاسم الخوارج _بحسب الخالدى _ يطلقة المؤرخون علي فئات عديده لها اراء اسلاميه ذات صبغه خاصة، و الاسم يشمل فئات اجتماعيه مختلفه جمعتها مصالح اقتصاديه و اجتماعيه ففترات معينة. فثورتهم علي الامام على لها اضافه الي الاسباب الدينية، سبب اخري تتلخص فان هؤلاء المقاتلين رفضوا مركزيه الحكم و ارادوا الاستئثار بالاراضى التي فتحوها و الاستفاده منها. فالخوارج ظاهره عربيه عسكريه تعتبر ان الغزو يمنح الغازى الحق فقطف ثمار غزوة و يعطية منزله خاصه فالمجتمع، بعدها تاتى النظره الدينيه لهذة الفئه الاجتماعيه لتبرر و تشرعن نظرتها الاجتماعيه او و ضعها الاجتماعي.هنالك جوانب اخري تؤكد اجتماعيه الظاهره الدينيه فالمجتمع العربى _ الاسلامى كالفقة و التشريع. فقد بدات المشكلات الحديثة تخرج بحده اثناء القرن الثالث، و احس الفقهاء بخطر التغيرات علي تماسك المجتمع و الدولة. و يصف احد الكتاب التطور المجتمعى و اثرة فالفقة الاسلامى قائلا: “واستجابه لهذة المشكلات المتفاقمه ظهرت المنظومه الحقوقيه الاسلاميه التي سماها فقهاء الاحناف و المالكيه البديهيات الخمس: حق النفس، و حق الدين، و حق العقل، و حق العرض، و حق المال”. اما فالتشريع، فان الحديث عن مقاصد الشريعه و المصلحه يؤكد نسبيه بعض احكام الشريعة، لان بعض المقاصد و المصالح متغير بحسب الواقع.هنالك نقطه اخري تساعد فمقاربه الظاهره الدينيه فالمجتمع العربى _ الاسلامي، و هى خاصه بالسؤال السابق: لماذا تخرج افكار او عقائد معينه فزمان او مكان ما ؟ فالاسلام لم ينشا ففراغ، فقد جاء فبيئه محدده و فحقبه تاريخيه لها شروط خاصة. ذلك و ربما جاء الاسلام و الاحوال فمكه و الجزيره العربيه تنبىء بالحاجه الي منقذ او مخلص، و هذة ظروف مرت فيها نشاه جميع الاديان. و ينجح الدين عندما تكون الظروف مهياه لقبول هذا المنقذ و الامتثال لتعاليمة التي تجيء تعبيرا عن الحاجه الروحيه و الماديه (اى السياسيه و الاقتصادية) للجماعه التي ينتمى اليها. و يتضافر نضوج اللحظه التاريخيه مع عوامل كشخصيه المنقذ و مضمون التعاليم و طرق تطبيقها فعمليه نجاح الدعوه الحديثة و استمرارها. و يضيق المجال هنا عن و صف مكه قبل الاسلام، و بالذات اوضاعها الاقتصاديه و المؤثرات الفكريه و العقيديه التي تتعرض لها، بعدها بحث الفئات الاجتماعيه التي ساندت الاسلام و تلك التي عارضت. ان التدرج فنزول الاحكام اضافه الي المحافظه علي بعض المعتقدات و الممارسات قبل الاسلامية، و تمثل بعضها و دمجها فالدين الجديد _كل ذلك يعكس جانبا تاريخيا فالدين و يؤكد استمراريه تاريخ المنطقة، و ان الاسلام جاء ضمن سياق التطور التاريخى للجزيره العربية.تثبت ما جريات الامور، و بالذات فما يتعلق بالتطورات السياسيه ذات الغطاء الايديولوجى الديني، تاريخيه الظاهره الدينيه الاسلامية. فابتداء من اجتماع السقيفه لاختيار خليفه للرسول، مرورا بالرده بعدها قيام الدولتين الامويه و العباسية، حتي الغاء الخلافه فعشرينات ذلك القرن، جميع هذة احداث و وقائع و صراعات انسانيه حكمتها المصالح و الاوضاع الاقتصاديه _ الاجتماعيه و المواقف السياسيه و الفكرية. و رغم انها استندت جميعا الي التفسير الاسلامي، مع تعرض المعسكرين فعديد من الاحيان. و فرضت النواحى الاجتماعيه _ الاقتصاديه نفسها علي كتابات مؤلفين ليسوا علماء اجتماع او ما ركسيين، و لكن بروز تاثيرها فالاحداث و تحريكها للواقع لفت انتباة هؤلاء المؤلفين. و اروع مثال لذا كتاب طة حسين عن الفتنه الكبرى، الذي جاء و صفا دقيقا للتطورات الاقتصاديه و الاجتماعيه و اثرها فحياة الصحابه و مواقفهم و كيفية اداره الصراع.ليست الظاهره الدينيه الاسلاميه استثناء، فهى خاضعه للتحليل التاريخ _ الاجتماعي. و بالفعل ظهرت دراسات عالجت الدين كجزء من الايديولوجيا او من منظور ثقافى او انثروبولوجي، او علاقتة بالاخلاق الاقتصاديه اضافه الي الدين ضمن سيروره التغير الاجتماعى و الاحتكاك بالاخر (الغرب). و تعرض فيما يلى تعريفا مختصرا لاهم عناصر هذة المقاربات السوسيولوجيه فدراسه الاسلام.ا_ الاسلام جزء من الايديولوجيايجد رودنسون فتاريخ الاسلام فالقرون الوسطي و الاسلام الحديث منطلقا مفيدا. فهو يبدا بالقول بعدم و جود تشابة بين اسلام المجتمع فالعصر الوسيط و بين اسلام بدء الدعوه عند مولد الدين. لذا يعتبر ان ايديولوجيا هذة الفتره اجمالا ذات لون ديني، و تلتحق بصوره مصطنعه نوعا ما بنظام الافكار الذي طرحة مؤسس الاسلام و عرضة القران. و ذلك يقود الي نظام ايديولوجى غير متجانس، و لكنة ضروري، بل يعتبر رودنسون ان الطابع غير المتجانس للانظمه الايديولوجيه طبيعى تماما، لانة يؤدى و ظيفتة فالوحده و التماسك و بقاء الامه (الدوله الاسلامية). و تتسم الايديولوجيا بمرونه تصل الي حد التناقض كما يخرج ففتاوي العلماء. و تسمح الدوله بقدر من التجاوز للايديولوجيا لا يهدد و جودها و لكن يقوم بوظيفه التوازن (Equilibrium) تجنبا للصراع العدائي.يناقش مورو بيرغر الفكره نفسها من منطلق مختلف لا يرتكز علي المنهج الماركسى كرودنسون. فهو يري _استنادا الي شاخت _ ان القانون الاسلامى تطور ليس نتيجه ارتباطة بالتجربة، بل كتعبير عن كاعلي اسلامي مضاد للتجربة، لان رجال الدين حكموا علي العادات الموجوده بتعاليم الاسلام. و نجم عن هذا و ضع استمر حتي العصر الحديث يتسم بوجود فجوه بين المثل الاعلي و الواقع، و يري ان نتيجه هذا و جود ثلاثه توازنات او توترات فالاسلام التقليدى ما زالت تعمل عملها فالمجتمع العربى _ الاسلامي، و هى بين العناصر الدينيه و الدنيوية، و بين الفرد و الجماعة، و بين المثل العليا الصحراويه و المدنية. و نعتقد ان الملاحظه صحيحه الي حد ما ، و لكنها ربما تقع فالتحليل الاستاتيكى الذي يتبعة كثير من الباحثين حين يتعاملون مع المجتمع _الاسلامى ككيان ثابت و خالد او يكاد لا يتغير و لا يؤثر فية التاريخ و لا ايقاعات الحياة الاجتماعيه المتحركه دوما.يحاول رودنسون البحث عن الكيفية التي تتلاءم بواسطتها الايديولوجيا مع التوترات او التغييرات الحادثة، و بالذات مواجهه التفوق الاوروبى الذي يعرض الايديولوجيا القائمه لاستجواب جديد. و يري من البدايه انه ليس هنالك ايديولوجيا غير الدين ممكن تعميمها علي المجتمع و تستطيع ان توحد الناس، فهو يعتبر العلمانيه ذات طابع نخبوي. و لكن الاسلام فنظرة لم يعد ايديولوجيا شموليه بخاصه بعد التيارات التي دخلتة منذ العصور الوسطى، و مع توقع تعدد الايديولوجيات الفرعيه ضمنه.ب_ البعد الثقافى لدراسه الاسلامهذا تيار كبير لانة يضم اعمال المستشرقين، الا اذا حددناة بالبعد الثقافى _ الانثروبولوجي. فقد اهتم المستشرقون بالاسلام كنمط ثقافى مميز و الصقوا بة تسميات ثابته كالروحانيه و السحر و الغموض و اللفظيه و الشاعريه و الرومانسيه و اللاعقلانية، و غيرها من المسميات التي لا تخلو من الاستعلاء و المركزيه الثقافيه و التي تطلق علي ثقافات الشرق و من بينها _بل و اهمها _ الاسلام.دراسات الاستشراق الحديث التي بحثت الاسلام كثقافه لا تستوقفنا كثيرا من ناحيتها الاجتماعيه و الانثروبولوجيه علي الرغم من ان بعضها ككتابات غب (Gibb) و غرونباوم (Grunebaum) لامست موضوعات كالهويه الثقافيه و الاحتكاك بالغرب. و لكن و قعت فقصور كتابات المستشرقين نفسه. فالاسلام عند غب بنيه فوقيه لم تتغير كثيرا طوال القرون السابقة، و ذلك غلو _كما يقول ادوارد سعيد _ خاص بالاستشراق فقط، و تتحدث اعمالة عن اسلام مجرد لا نعلم اين يحدث فالزمان و المكان المحسوسين. و فالمجري نفسة تاتى كتابات غرونباوم الذي يتحدث عن لعبه الروحانيه الشرقيه و الماديه الغربيه و عدم المس بالروحانيه او الاخذ من ما ديه الغرب بصوره “لا تتناقض مع روحانيتنا” (اى الشرقية)، و بالتالي عدم الشعور بالنقص تجاة الغرب كخداع سيكولوجي، و يؤخذ علية مطابقتة التاريخ الواقعى و التراث كنظام ذهني، فهذا اختزال للواقع لانة ربما يصبح المطلوب او المكتوب شيئا و ما يحدث فعليا هو شيء اخر.يختلف منهج البعد الثقافى _ الانثروبولوجى كثيرا عن المقاربات التي مثلنا لها اذ يعتمد علي المقابله و يهتم بالتاريخ و الفلسفة، و بالتالي يصل الي نسبيه الثقافه فتطورها عندما تقارن مع نفسها فالماضى او بثقافات معاصره اخرى. و يعتبر غيرتز من اهم ممثلى ذلك الاتجاه، بخاصه و هو يصل الي ان الدين نظام للمعني او نسق للرموز ممكن بتحليلها فهم الدين انثروبولوجيا.حاول غيرتز تطبيق منهجة فاحد كتبة المهمه الذي تابع فية التطور الدينى فمراكش و اندونيسيا، او روح (Ethos) المجتمع، بعدها اثر النصوص و التاريخ (هنا اثر الاستعمار) فالمؤسسات الدينيه و السياسيه و فعقول الناس ايضا. و هذة عناصر نظريته، فهو يقول بان المطلوب ليس البحث عن تعريف للدين فلدينا العديد من التعريفات، و لكن المهم اي نوعيات الايمان و تحت اي ظروف. و يري ان الهدف من اي دراسه علميه منتظمه للدين ليس و صف الافكار و الافعال و المؤسسات، و لكن المطلوب كيف يحدد، و باى طريقة. ان بعض الافكار و الافعال و المؤسسات تثبت او تعجز عن تثبيت او حتي تعميق الايمان الديني. و ذلك يعنى ببساطه ان نفرق بين الاتجاة الدينى نحو التجربه و بين نوعيات الاداه الاجتماعيه التي كانت اثناء زمان و مكان معينين ارتبطت عاده بدعم كهذا الاتجاه.يعبر غيرتز عن اجماعيه الدين و ارتباطة بالواقع بكيفية بليغه حين يقول: “قد يصبح الدين حجرا مقذوفا علي العالم، و لكن لا بد من ان يصبح حجرا محسوسا و ان يقذفة شخص ما ” و يري انه مهما كانت مصادر الايمان عند الفرد او الجماعه فلا بد من ان تسند فهذا العالم باشكال رمزيه و تنظيمات اجتماعية؛ و ما هيه اي دين _او محتواة المحدد _ تتجسد فالتصورات و المجازات التي يستخدمها الاتباع فتميز الحقيقة. و ذلك المجال الدينى فتطورة التاريخى يقوم علي المؤسسات التي تعطى اولئك الذين يوظفونها تلك التصورات و المجازات المتاحة. و لذا يقول بانة لا ممكن فهم الاسلام مع النبى من دون العلماء، و لا الهندوسيه من دون الطوائف اضافه الي الفيدا.درس غيرتز كيف تطور دين و احد له التعاليم نفسها بطريقتين مختلفتين بحسب الظروف التاريخيه _ الاجتماعية. ايضا كيف تؤثر الثقافه المحليه فالدين الواحد، اي العلاقه بين النص و الفعل. و يشير الي ازمه تتمثل فالصدام بين ما اوحي بة القران او ما يري السنيون انه ربما اوحي به، و بين ما يؤمن بة حقيقه من يسمون انفسهم مسلمين. و اختلفت كيفية معالجه ذلك التناقض فالمجتمعين. فقد كانت المعالجه بالنسبه الي المغرب تتسم بموقف غير مساوم و متشدد يحاول العوده الي اصول نقيه معتمده علي الكتاب و السنة. بينما كان رد الفعل الاندونيسى فمواجهه الازمه تكيفيا و عمليا و تدريجيا، و يعود هذا الي الحياة الاجتماعيه التي تعيشها جميع مجموعة. و يهتم بخصوصيه الظاهرة، و ذلك ممكن الباحث من التعميم لانة يدرس كيف عملت التعاليم الدينيه الواحده فبيئه ما بصوره مختلفة.يتميز منهج غيرتز بانة ربما ركز علي الاجتماعى اذ انه جعل الظاهره الدينيه متفاعله بكيفية و ثيقه مع الواقع و التغيرات الاجتماعية. و يحاول ان يستفيد من معارف متشعبه تمكنة من الفهم، و لا يقطع ايضا صلتة بتراث شارك فية عدد من علماء الاجتماع المهتمين بالدين و السحر و الطقوس، و بالذات فيبر و دوركايم و ما لنوفسكى و فرويد.من العلماء المتحمسين لهذا الاتجاة محمد اركون الذي يدعو الي ان يستفيد المنهج الثقافى الانثروبولوجى من علم النفس و اللغه و التاريخ و الفلسفه و اللاهوت. و يطالب بتطبيق فكرتين لم تسترعيا انتباة المستشرقين و دارسى الاسلام و هما: الشخصيه الاساسيه بحسب كاردينز و لينتون، و الوعى الميثى (الاسطوري؟) بالاستفاده من بنيويه ليفى شتراوس. و فمقدمه احد كتبة المهمه التي حاول بها بحث الفكر الاسلامى يبدا بالسؤال عن طريقة درس ذلك الفكر. و يجيب بضروره الانطلاق من القران و تجربه المدينه لانهما “ادخلا شكلا من الحساسيه و التعبير و مقولات فكريه و نماذج للعمل التاريخى و مبادىء لتوجية السلوك الفردي”. و يهتم بجانب ضرورى و هو “وضع اللغه و كيفية التعبير السائده و المفردات المستخدمه و علاقه هذا بالزمن و مشروطيته”. فقد كانت اللغه و الفكر ففجر الاسلام حين نزول القران مرتبطين بشكل مباشر و وثيق بالواقع المعاش، و لكن التفاسير اضافت العديد نتيجه المؤثرات المتنوعه اضافه الي العناصر الاسطوريه و المخيال الشعبى الامر الذي اسباب تقنيع الحقائق و اعطاها هيبه متعالية، و ان كان اركون يعتبرها هيبه فوق فرديه و ليست فوق بشرية، اي كانها تمثل العقل الجمعى كما عند دوركايم. فكل مجتمع _بحسب اركون _ يفرز اساطير ملائمه لنقل تقاليدة و تلبى حاجاتة الماديه و الروحيه الراهنه و تتداخل مع المتطلبات العقليه بهدف حفظ توازن البنيه الاجتماعيه بايجادها التبرير المباشر للوعي.يدعو الباحث الي ما يسمية زحزحه (Deplacement) منهجيه و معرفيه تهدف الي الوصول الي حوافز السلوك الحقيقيه و نزع اي اقنعه تلبس البشر شعارات اسلامية. و يعنى جميع ذلك ضروره معالجه التراث الاسلامى ضمن اطار التحليل و الفهم الانثروبولوجى الذي يتركز حول المنشا التاريخى للوعى الاسلامي، و تشكل بنيتة عبر عمليه الخلق الجماعي. و ينتهى الباحث الي ان الفكر و الاجتهادات بالذات فالتراث الاسلامى تعبر عن متطلبات ايديولوجيه لطبقه او فئه اجتماعيه معينة. و الحقيقه _كما يرد _ تتجسد دائما، و فكل مكان، عن طريق الفاعلين الاجتماعيين، اي البشر، فهى شيء ملموس و محسوس. و يطرح المبادىء الاتية:1_ ليس هنالك من حقيقه غير الحقيقه التي تخص الكائن الانسانى المتفرد و المتشخص و المنخرط ضمن اوضاع محسوسه قابله للمعرفة.2_ ان الحقيقه موجهه لكى تعلن و تنشر ضمن و سط اجتماعى _ تاريخى يتنافس فية اناس مختلفون من اجل الوصول الي السلطه و السيطره عليها.3_ اذا كانت الحقيقه بكل اشكالها تتجسد دائما عن طريق و ساطه الانسان فعمل لا ينفصم من التعبير و الذكاء و الارادة، فانها تتطلب مستويات عديده من التحليل كاللغوى و التاريخى و السوسيولوجى و الانثروبولوجى و الفلسفي.يدعو اركون الي ما يسمية “الاسلاميات التطبيقية” التي تدرس الاسلام ضمن منظور المساهمه العامه لانجاز الانثروبولوجيا الدينية. و قام بعمليه اعاده قراءه القران (الفاتحة)، تخضعة ل “محك النقد التاريخى المقارن، و التحليل الالسنى التفككي، و التامل الفلسفى المتعلق بانتاج المعني و توسعاتة و تحولاتة و انهدامه”. رغم مساهمات الباحث المهنيه المهمة، الا ان مجالة يتركز اكثر علي الفكر او العقل او الوعى الاسلامي، فهو لا يهمل المجتمع و العلاقات الاجتماعيه تماما حيث يقول “انة يحاول فهم طريقة اختراق الدين و سطا اجتماعيا ما و مدي تمثلة فية او مدي نجاحة او فشله، بعدها العكس، اي مدي تاثير ذلك الوسط فالدين الرسمى و كيف يعدلة و يحور فية و يغيره”.ج_ الاخلاقيه الاقتصاديه للدينيعتبر ما كس فيبر الرائد الحقيقى لمبحث الاخلاقيه الاقتصاديةوالدين. و فتعريف للمصطلح يستبعد فالبدايه صله المفهوم بنظريات الاخلاق من منطلقها الدينى او اللاهوتى الصرف، و يقول ان المصطلح “يشير الي دوافع الفعل العمليه التي نجدها فالنسيج النفسى و العلمى _ البراغماتى للاديان. هنالك اشكال تنظيم اقتصادى معين تتفق مع اخلاقيات اقتصاديه محددة، و الاخلاق الاقتصاديه ليست مجرد و ظيفه تشكل تنظيما اقتصاديا، و ليس العكس (…) فو جة مواقف الانسان من العالم _ كما يحددها الدين او اي عامل داخلى _ للاخلاق الاقتصادية، و هو يركز فنظرته، علي فئات اجتماعيه معينه اثرت اكثر من غيرها فالاخلاق العمليه فاديانها، و علي الرغم من احتمال تغير الفئه تاريخيا، و لكنة يعنى _كما يقول _ بالفئات التي ربما يصبح اثر اسلوب حياتها اكثر و ضوحا فاديان معينة. و مهما كان و قع الاثار الاجتماعيه المحدده اقتصاديا و سياسيا فالاخلاق الدينيه فهى _بحسب فيبر _ تتخذ طابعها الاساسى من مصادر اسلامية، كالبشاره و الوعد. و كثيرا ما تعيد الاجيال تفسيرها بكيفية اصولية، و تعدل الاتهامات بحسب اشياء الجماعه الدينية. و يري ان القيم المقدسه هى فالواقع من هذة الدنيا كالصحه و الثروه و طول العمر، اما الزاهدون و المتصوفه فهم يتوقون الي قيم مقدسه فعالم اخر. و تتاثر القيم المقدسه بطبيعه المصالح و حياة الفئه الحاكمة، اي بالتراتب الاجتماعي.اشتهر فيبر بنظريتة عن دور البروتستانتيه فنشوء الراسمالية، و علي الرغم من انه لم يعط علاقه سببيه بينهما، فقد قصد ان يقول _بحسب نظريتة عن الفهم “ان الذهنيه البروتستانتيه كانت احد مصادر عقلنه الحياة التي ساهمت فتكوين ما يسمية الروح الراسمالية، و لم تكن الاسباب =الوحيد او الكافى للراسماليه نفسها”. و ياخذ علية البعض انه يوحى بان الحضاره الغربيه تتميز بذهنيه ذات درجه عاليه من العقلانية، هى التي انتجت ذلك النظام الاقتصادى بينما عجزت الاديان الاخرى، و من بينها الاسلام، عن ذلك. فقد يصبح الاسباب =ليس غياب العقلانيه عن تلك الاديان و لكنها بدت عاجزه عن ابتكار الادوات التقنيه و عن امتلاك الوسائل الروحانيه لتطور اكبر، و هو مطالب بتحديد سبب ذلك العجز. و العقلانيه مفهوم نسبي، و يرجع باحثون اخرون سبب تطور الراسماليه فالقرنين السادس عشر و السابع عشر بالذات فهولندا و انكلترا ليس الي القوي البروتستانتيه و لكن الي التحركات
…
اما تكامل الوحى و العقل فيقوم علي افتراض خطير يحرم العلم من اداه مهمه و هى العقل، فرغم الاعتراف بدورة الا ان اصحاب ذلك الاتجاة يقولون: “فالعقل الانسانى رغم جميع مكانتة و امكاناتة فحياة البشر _يظل محدودا جزئيا يعتمد الاستقراء و تراكمات المعرفه و الخبره لادراك مسيرتة و سبل ادائه. و جاء الوحى علي ايدى المعصومين الصادقين من الانبياء و الرسل ليمد العقل الانسانى بالمدركات الكليه فعلاقات الكون و موضع الانسان منها و مهمه و جودة تجاهها و قواعد علاقاتة الانسانيه و الاجتماعيه الاساسيه اللازمه لترشيد سعية و تحقيق غايه و جوده”.2_ حاضر دراسه الدين و افقها اجتماعياظهر تياران فالعقدين الماضيين احدهما يبحث عن تفسير ايجابى للدين و يشترك فية باحثون من غير الاجتماعيين _ بالمعني الحصرى _ و يتضمن هذا الكتابه عن دور الدين فالتغيير الاجتماعى او التنمية، او فالضبط الاجتماعي. و ممكن ادراج كتابات “التراث و المعاصرة” و “الاصل و العصر” و “التجدد الذاتي” و “الهويه او الذاتيه و الاخر” ضمن ذلك التيار. و تسعي هذة الفئه الي ايجاد اسس مشتركه بين الواقع المتغير و النصوص، او التوفيق بين رؤيه / عقيده و واقع. و اهتم التيار الثاني بما يسمي الصحوه الاسلاميه او الاحياء الديني، او الحركات الدينيه او الجماعات الاسلاميه المتطرفة. و تتسم كهذة الدراسات بطابع سياسى و اعلامى يلاحق الاحداث الانية، فهى فالواقع تنقب عن الدور السياسى _ تقدما او تراجعا _ للدين و بالذات الاسلام، و ذلك و ليد تحولات ايران بعد الشاة و تعاظم نفوذ الدول النفطيه _ الاسلاموية، و هى كتابات انطباعيه فالغالب.يفتقد التياران النظريه الاجتماعيه فتفسير الدين او الحركات الدينيه او الادوار الدينية. و عندما تبحث الكتابات عن نظرية، فهى لا تتعدي دوركايم، تنتقى منة المقولات و الفرضيات التي تودها، و تبتعد كلها عن معالجه الدين كنظام للمعني (Meaning System) يؤسسة الانسان، او بالاصح، المجتمع ليعطى اطارا شاملا للفعل و الفهم الانسانيين. حتي بالنسبه الي النموذج الدوركايمى فهو صالح فحال تعديله، بحيث يستوعب حقيقه ان الديناميه الداخليه محكومه بقوي و علاقات الانتاج اكثر من العوامل الديمغرافيه كنسب الاكل الي السكان. اضافه الي تعديل المنحي المثالى الذي يركز علي الاستجواب الايديولوجى عما هو الخير و الحق (القيم)، ليعطى اعتبارا اكثر استجواب ما هو الادراك (Cognition) و ما هو الممكن او الخيال (Imagination). و ذلك تركيب للمنظور السوسيولوجى مع الماديه التاريخية. و هنالك نقاط التقاء كثيره بينهما، بالذات التطور التاريخى للظواهر بما بها الافكار و عملها فعلاقات بالظواهر الاخرى.نجد خارج التيارين السابقين كتابات حاولت ان تتخذ شكلا نقديا فالتعامل مع الظاهره الدينية، و لكن اغلب هذة الكتابات كانت معارك فكريه و كانها حوار عقول مع عقول، و لا تهتم كثيرا بالاصول الاجتماعية. و ربما انتجت الفتره التي اعقبت حرب حزيران/ يونيو 1967 اعدادا من هذة الكتابات ابرزها كتاب صادق جلال العظم: نقد الفكر الدينى و ربما اثار ضجه كبيره لدي صدوره. و هدف الكتاب كما حددة مؤلفه، هو التصدى “بالنقد العلمى و المناقشه العلمانيه و المراجعه العصريه لبعض نواحى الفكر الدينى السائد حاليا بصورة المختلفه و المتعدده فالوطن العربي”، و الكتاب لا يخلو من اشارات الي ان الفكر الغيبى هو تعبير عن الاوضاع الاقتصاديه و علاقات الطبقات المختلفة. و من الملاحظ ان المهتمين بالفلسفه و قضايا الفكر و الثقافه هم الذين حملوا عبء الكتابه عن الدين. و لكن يهمنا _رغم تقديرنا لتلك المساهمات القيمه _ التعرف الي الكتابات الاجتماعيه التي تطرح اسئله مثل: لماذا ساد كهذا النوع من الفكر او الحركه الدينيه فهذا الوقت بالذات و داخل ذلك المجتمع بعينه.3_ هل من الممكن دراسه الاسلام اجتماعيا؟يواجة المنهج الاجتماعى _ التاريخ فدراسه الدين اشكاليه العلاقه بين المتعالى او فوق الطبيعى او فوق البشرى و بين المجتمع المادى او الطبيعى او البشري. و فحاله الاسلام بين النص المقدس (القران الكريم و السنة) و بين ضرورات الحياة العاديه و ظروفها. و يعطى قول الشهرستاني: “ان النصوص متناهيه و ان الوقائع غير متناهيه و ان المتناهى لا يحكم غير المتناهي” اشاره الي امكانيه غلبه الواقع علي النص. و لكن علي كهذا القول ان يواجة مساله القول بصلاحيه النصوص لكل زمان و مكان. و هذة مهمه اي دراسه اجتماعيه للظاهره الدينية، اي البحث عن علاقه النصوص المقدسه بالواقع؛ و ذلك مدخل يسهل المهمه بتضييق الفجوه بين المطلق و النسبي. و يؤكد احد المفكرين الدينيين المستنيرين و جود علاقه عضويه بين الفكر و الواقع، و يري ان سبب نزول الايات دليل علي و جود مشكله او موقف و اقعى محدد جاءت الايات بشرحة و بيان طريقة التصرف فيه. ايضا يثبت التدرج فالنزول، و النسخ اضافه الي اللغه و الامثال المستعملة، و جود علاقه بين القران و الواقع المعاش. و لكن عالم الاجتماع لابد له من منهج دينامى متغير، و عندما يحلل الدين من منظور اجتماعى فهو ليس مطالبا ب “التركيز علي النصوص المجرده او علي التعاليم الدينيه بحد ذاتها بل علي السلوك الدينى فالحياة اليوميه و فمحتواة الاجتماعى التاريخى ضمن اطار الصراعات القائمه فالمجتمع”؛ لذا فانة اذا كان الاسلام يخرج و احدا كما تبرزة نصوص القران و السنة، فان الممارسات التاريخيه و الاجتماعيه لهذا الاسلام تتعدد و تختلف معتمده علي تفسيرها الخاص للنصوص لتسند موقفها و تعطية مشروعيه خاصة.بوسع الباحث ان يمسك بعديد من الخيوط التي تثبت اجتماعيه الظاهره الدينية، و لكن اغلب هذة المساهمات جاءت من مؤرخين. و من هذة التفسيرات الدراسات الخاصه بظهور الفرق و المذاهب الفكريه ضمن الاسلام. فهذا يؤكد ان الاسلام تاويل و قراءات تختلف بحسب القوي و الفئات الاجتماعيه التي تساند فهما بعينه. و من التبسيط ارجاع الاختلافات الي اراء اسلاميه فحسب، و لكنها مواقف سياسيه _ اجتماعيه تتقنع بوجوة اسلامية. فجماعات كالخوارج و الشيعه و المعتزله لا تفهم بحسب التحليل السياسى او الفكرى فقط، و بالتالي البحث عن موقعها المجرد من السلطة، او البحث عن اصول فكرها و التاثيرات التي تعرضت لها. فاسم الخوارج _بحسب الخالدى _ يطلقة المؤرخون علي فئات عديده لها اراء اسلاميه ذات صبغه خاصة، و الاسم يشمل فئات اجتماعيه مختلفه جمعتها مصالح اقتصاديه و اجتماعيه ففترات معينة. فثورتهم علي الامام على لها اضافه الي الاسباب الدينية، سبب اخري تتلخص فان هؤلاء المقاتلين رفضوا مركزيه الحكم و ارادوا الاستئثار بالاراضى التي فتحوها و الاستفاده منها. فالخوارج ظاهره عربيه عسكريه تعتبر ان الغزو يمنح الغازى الحق فقطف ثمار غزوة و يعطية منزله خاصه فالمجتمع، بعدها تاتى النظره الدينيه لهذة الفئه الاجتماعيه لتبرر و تشرعن نظرتها الاجتماعيه او و ضعها الاجتماعي.هنالك جوانب اخري تؤكد اجتماعيه الظاهره الدينيه فالمجتمع العربى _ الاسلامى كالفقة و التشريع. فقد بدات المشكلات الحديثة تخرج بحده اثناء القرن الثالث، و احس الفقهاء بخطر التغيرات علي تماسك المجتمع و الدولة. و يصف احد الكتاب التطور المجتمعى و اثرة فالفقة الاسلامى قائلا: “واستجابه لهذة المشكلات المتفاقمه ظهرت المنظومه الحقوقيه الاسلاميه التي سماها فقهاء الاحناف و المالكيه البديهيات الخمس: حق النفس، و حق الدين، و حق العقل، و حق العرض، و حق المال”. اما فالتشريع، فان الحديث عن مقاصد الشريعه و المصلحه يؤكد نسبيه بعض احكام الشريعة، لان بعض المقاصد و المصالح متغير بحسب الواقع.هنالك نقطه اخري تساعد فمقاربه الظاهره الدينيه فالمجتمع العربى _ الاسلامي، و هى خاصه بالسؤال السابق: لماذا تخرج افكار او عقائد معينه فزمان او مكان ما ؟ فالاسلام لم ينشا ففراغ، فقد جاء فبيئه محدده و فحقبه تاريخيه لها شروط خاصة. ذلك و ربما جاء الاسلام و الاحوال فمكه و الجزيره العربيه تنبىء بالحاجه الي منقذ او مخلص، و هذة ظروف مرت فيها نشاه جميع الاديان. و ينجح الدين عندما تكون الظروف مهياه لقبول هذا المنقذ و الامتثال لتعاليمة التي تجيء تعبيرا عن الحاجه الروحيه و الماديه (اى السياسيه و الاقتصادية) للجماعه التي ينتمى اليها. و يتضافر نضوج اللحظه التاريخيه مع عوامل كشخصيه المنقذ و مضمون التعاليم و طرق تطبيقها فعمليه نجاح الدعوه الحديثة و استمرارها. و يضيق المجال هنا عن و صف مكه قبل الاسلام، و بالذات اوضاعها الاقتصاديه و المؤثرات الفكريه و العقيديه التي تتعرض لها، بعدها بحث الفئات الاجتماعيه التي ساندت الاسلام و تلك التي عارضت. ان التدرج فنزول الاحكام اضافه الي المحافظه علي بعض المعتقدات و الممارسات قبل الاسلامية، و تمثل بعضها و دمجها فالدين الجديد _كل ذلك يعكس جانبا تاريخيا فالدين و يؤكد استمراريه تاريخ المنطقة، و ان الاسلام جاء ضمن سياق التطور التاريخى للجزيره العربية.تثبت ما جريات الامور، و بالذات فما يتعلق بالتطورات السياسيه ذات الغطاء الايديولوجى الديني، تاريخيه الظاهره الدينيه الاسلامية. فابتداء من اجتماع السقيفه لاختيار خليفه للرسول، مرورا بالرده بعدها قيام الدولتين الامويه و العباسية، حتي الغاء الخلافه فعشرينات ذلك القرن، جميع هذة احداث و وقائع و صراعات انسانيه حكمتها المصالح و الاوضاع الاقتصاديه _ الاجتماعيه و المواقف السياسيه و الفكرية. و رغم انها استندت جميعا الي التفسير الاسلامي، مع تعرض المعسكرين فعديد من الاحيان. و فرضت النواحى الاجتماعيه _ الاقتصاديه نفسها علي كتابات مؤلفين ليسوا علماء اجتماع او ما ركسيين، و لكن بروز تاثيرها فالاحداث و تحريكها للواقع لفت انتباة هؤلاء المؤلفين. و اروع مثال لذا كتاب طة حسين عن الفتنه الكبرى، الذي جاء و صفا دقيقا للتطورات الاقتصاديه و الاجتماعيه و اثرها فحياة الصحابه و مواقفهم و كيفية اداره الصراع.ليست الظاهره الدينيه الاسلاميه استثناء، فهى خاضعه للتحليل التاريخ _ الاجتماعي. و بالفعل ظهرت دراسات عالجت الدين كجزء من الايديولوجيا او من منظور ثقافى او انثروبولوجي، او علاقتة بالاخلاق الاقتصاديه اضافه الي الدين ضمن سيروره التغير الاجتماعى و الاحتكاك بالاخر (الغرب). و تعرض فيما يلى تعريفا مختصرا لاهم عناصر هذة المقاربات السوسيولوجيه فدراسه الاسلام.ا_ الاسلام جزء من الايديولوجيايجد رودنسون فتاريخ الاسلام فالقرون الوسطي و الاسلام الحديث منطلقا مفيدا. فهو يبدا بالقول بعدم و جود تشابة بين اسلام المجتمع فالعصر الوسيط و بين اسلام بدء الدعوه عند مولد الدين. لذا يعتبر ان ايديولوجيا هذة الفتره اجمالا ذات لون ديني، و تلتحق بصوره مصطنعه نوعا ما بنظام الافكار الذي طرحة مؤسس الاسلام و عرضة القران. و ذلك يقود الي نظام ايديولوجى غير متجانس، و لكنة ضروري، بل يعتبر رودنسون ان الطابع غير المتجانس للانظمه الايديولوجيه طبيعى تماما، لانة يؤدى و ظيفتة فالوحده و التماسك و بقاء الامه (الدوله الاسلامية). و تتسم الايديولوجيا بمرونه تصل الي حد التناقض كما يخرج ففتاوي العلماء. و تسمح الدوله بقدر من التجاوز للايديولوجيا لا يهدد و جودها و لكن يقوم بوظيفه التوازن (Equilibrium) تجنبا للصراع العدائي.يناقش مورو بيرغر الفكره نفسها من منطلق مختلف لا يرتكز علي المنهج الماركسى كرودنسون. فهو يري _استنادا الي شاخت _ ان القانون الاسلامى تطور ليس نتيجه ارتباطة بالتجربة، بل كتعبير عن كاعلي اسلامي مضاد للتجربة، لان رجال الدين حكموا علي العادات الموجوده بتعاليم الاسلام. و نجم عن هذا و ضع استمر حتي العصر الحديث يتسم بوجود فجوه بين المثل الاعلي و الواقع، و يري ان نتيجه هذا و جود ثلاثه توازنات او توترات فالاسلام التقليدى ما زالت تعمل عملها فالمجتمع العربى _ الاسلامي، و هى بين العناصر الدينيه و الدنيوية، و بين الفرد و الجماعة، و بين المثل العليا الصحراويه و المدنية. و نعتقد ان الملاحظه صحيحه الي حد ما ، و لكنها ربما تقع فالتحليل الاستاتيكى الذي يتبعة كثير من الباحثين حين يتعاملون مع المجتمع _الاسلامى ككيان ثابت و خالد او يكاد لا يتغير و لا يؤثر فية التاريخ و لا ايقاعات الحياة الاجتماعيه المتحركه دوما.يحاول رودنسون البحث عن الكيفية التي تتلاءم بواسطتها الايديولوجيا مع التوترات او التغييرات الحادثة، و بالذات مواجهه التفوق الاوروبى الذي يعرض الايديولوجيا القائمه لاستجواب جديد. و يري من البدايه انه ليس هنالك ايديولوجيا غير الدين ممكن تعميمها علي المجتمع و تستطيع ان توحد الناس، فهو يعتبر العلمانيه ذات طابع نخبوي. و لكن الاسلام فنظرة لم يعد ايديولوجيا شموليه بخاصه بعد التيارات التي دخلتة منذ العصور الوسطى، و مع توقع تعدد الايديولوجيات الفرعيه ضمنه.ب_ البعد الثقافى لدراسه الاسلامهذا تيار كبير لانة يضم اعمال المستشرقين، الا اذا حددناة بالبعد الثقافى _ الانثروبولوجي. فقد اهتم المستشرقون بالاسلام كنمط ثقافى مميز و الصقوا بة تسميات ثابته كالروحانيه و السحر و الغموض و اللفظيه و الشاعريه و الرومانسيه و اللاعقلانية، و غيرها من المسميات التي لا تخلو من الاستعلاء و المركزيه الثقافيه و التي تطلق علي ثقافات الشرق و من بينها _بل و اهمها _ الاسلام.دراسات الاستشراق الحديث التي بحثت الاسلام كثقافه لا تستوقفنا كثيرا من ناحيتها الاجتماعيه و الانثروبولوجيه علي الرغم من ان بعضها ككتابات غب (Gibb) و غرونباوم (Grunebaum) لامست موضوعات كالهويه الثقافيه و الاحتكاك بالغرب. و لكن و قعت فقصور كتابات المستشرقين نفسه. فالاسلام عند غب بنيه فوقيه لم تتغير كثيرا طوال القرون السابقة، و ذلك غلو _كما يقول ادوارد سعيد _ خاص بالاستشراق فقط، و تتحدث اعمالة عن اسلام مجرد لا نعلم اين يحدث فالزمان و المكان المحسوسين. و فالمجري نفسة تاتى كتابات غرونباوم الذي يتحدث عن لعبه الروحانيه الشرقيه و الماديه الغربيه و عدم المس بالروحانيه او الاخذ من ما ديه الغرب بصوره “لا تتناقض مع روحانيتنا” (اى الشرقية)، و بالتالي عدم الشعور بالنقص تجاة الغرب كخداع سيكولوجي، و يؤخذ علية مطابقتة التاريخ الواقعى و التراث كنظام ذهني، فهذا اختزال للواقع لانة ربما يصبح المطلوب او المكتوب شيئا و ما يحدث فعليا هو شيء اخر.يختلف منهج البعد الثقافى _ الانثروبولوجى كثيرا عن المقاربات التي مثلنا لها اذ يعتمد علي المقابله و يهتم بالتاريخ و الفلسفة، و بالتالي يصل الي نسبيه الثقافه فتطورها عندما تقارن مع نفسها فالماضى او بثقافات معاصره اخرى. و يعتبر غيرتز من اهم ممثلى ذلك الاتجاه، بخاصه و هو يصل الي ان الدين نظام للمعني او نسق للرموز ممكن بتحليلها فهم الدين انثروبولوجيا.حاول غيرتز تطبيق منهجة فاحد كتبة المهمه الذي تابع فية التطور الدينى فمراكش و اندونيسيا، او روح (Ethos) المجتمع، بعدها اثر النصوص و التاريخ (هنا اثر الاستعمار) فالمؤسسات الدينيه و السياسيه و فعقول الناس ايضا. و هذة عناصر نظريته، فهو يقول بان المطلوب ليس البحث عن تعريف للدين فلدينا العديد من التعريفات، و لكن المهم اي نوعيات الايمان و تحت اي ظروف. و يري ان الهدف من اي دراسه علميه منتظمه للدين ليس و صف الافكار و الافعال و المؤسسات، و لكن المطلوب كيف يحدد، و باى طريقة. ان بعض الافكار و الافعال و المؤسسات تثبت او تعجز عن تثبيت او حتي تعميق الايمان الديني. و ذلك يعنى ببساطه ان نفرق بين الاتجاة الدينى نحو التجربه و بين نوعيات الاداه الاجتماعيه التي كانت اثناء زمان و مكان معينين ارتبطت عاده بدعم كهذا الاتجاه.يعبر غيرتز عن اجماعيه الدين و ارتباطة بالواقع بكيفية بليغه حين يقول: “قد يصبح الدين حجرا مقذوفا علي العالم، و لكن لا بد من ان يصبح حجرا محسوسا و ان يقذفة شخص ما ” و يري انه مهما كانت مصادر الايمان عند الفرد او الجماعه فلا بد من ان تسند فهذا العالم باشكال رمزيه و تنظيمات اجتماعية؛ و ما هيه اي دين _او محتواة المحدد _ تتجسد فالتصورات و المجازات التي يستخدمها الاتباع فتميز الحقيقة. و ذلك المجال الدينى فتطورة التاريخى يقوم علي المؤسسات التي تعطى اولئك الذين يوظفونها تلك التصورات و المجازات المتاحة. و لذا يقول بانة لا ممكن فهم الاسلام مع النبى من دون العلماء، و لا الهندوسيه من دون الطوائف اضافه الي الفيدا.درس غيرتز كيف تطور دين و احد له التعاليم نفسها بطريقتين مختلفتين بحسب الظروف التاريخيه _ الاجتماعية. ايضا كيف تؤثر الثقافه المحليه فالدين الواحد، اي العلاقه بين النص و الفعل. و يشير الي ازمه تتمثل فالصدام بين ما اوحي بة القران او ما يري السنيون انه ربما اوحي به، و بين ما يؤمن بة حقيقه من يسمون انفسهم مسلمين. و اختلفت كيفية معالجه ذلك التناقض فالمجتمعين. فقد كانت المعالجه بالنسبه الي المغرب تتسم بموقف غير مساوم و متشدد يحاول العوده الي اصول نقيه معتمده علي الكتاب و السنة. بينما كان رد الفعل الاندونيسى فمواجهه الازمه تكيفيا و عمليا و تدريجيا، و يعود هذا الي الحياة الاجتماعيه التي تعيشها جميع مجموعة. و يهتم بخصوصيه الظاهرة، و ذلك ممكن الباحث من التعميم لانة يدرس كيف عملت التعاليم الدينيه الواحده فبيئه ما بصوره مختلفة.يتميز منهج غيرتز بانة ربما ركز علي الاجتماعى اذ انه جعل الظاهره الدينيه متفاعله بكيفية و ثيقه مع الواقع و التغيرات الاجتماعية. و يحاول ان يستفيد من معارف متشعبه تمكنة من الفهم، و لا يقطع ايضا صلتة بتراث شارك فية عدد من علماء الاجتماع المهتمين بالدين و السحر و الطقوس، و بالذات فيبر و دوركايم و ما لنوفسكى و فرويد.من العلماء المتحمسين لهذا الاتجاة محمد اركون الذي يدعو الي ان يستفيد المنهج الثقافى الانثروبولوجى من علم النفس و اللغه و التاريخ و الفلسفه و اللاهوت. و يطالب بتطبيق فكرتين لم تسترعيا انتباة المستشرقين و دارسى الاسلام و هما: الشخصيه الاساسيه بحسب كاردينز و لينتون، و الوعى الميثى (الاسطوري؟) بالاستفاده من بنيويه ليفى شتراوس. و فمقدمه احد كتبة المهمه التي حاول بها بحث الفكر الاسلامى يبدا بالسؤال عن طريقة درس ذلك الفكر. و يجيب بضروره الانطلاق من القران و تجربه المدينه لانهما “ادخلا شكلا من الحساسيه و التعبير و مقولات فكريه و نماذج للعمل التاريخى و مبادىء لتوجية السلوك الفردي”. و يهتم بجانب ضرورى و هو “وضع اللغه و كيفية التعبير السائده و المفردات المستخدمه و علاقه هذا بالزمن و مشروطيته”. فقد كانت اللغه و الفكر ففجر الاسلام حين نزول القران مرتبطين بشكل مباشر و وثيق بالواقع المعاش، و لكن التفاسير اضافت العديد نتيجه المؤثرات المتنوعه اضافه الي العناصر الاسطوريه و المخيال الشعبى الامر الذي اسباب تقنيع الحقائق و اعطاها هيبه متعالية، و ان كان اركون يعتبرها هيبه فوق فرديه و ليست فوق بشرية، اي كانها تمثل العقل الجمعى كما عند دوركايم. فكل مجتمع _بحسب اركون _ يفرز اساطير ملائمه لنقل تقاليدة و تلبى حاجاتة الماديه و الروحيه الراهنه و تتداخل مع المتطلبات العقليه بهدف حفظ توازن البنيه الاجتماعيه بايجادها التبرير المباشر للوعي.يدعو الباحث الي ما يسمية زحزحه (Deplacement) منهجيه و معرفيه تهدف الي الوصول الي حوافز السلوك الحقيقيه و نزع اي اقنعه تلبس البشر شعارات اسلامية. و يعنى جميع ذلك ضروره معالجه التراث الاسلامى ضمن اطار التحليل و الفهم الانثروبولوجى الذي يتركز حول المنشا التاريخى للوعى الاسلامي، و تشكل بنيتة عبر عمليه الخلق الجماعي. و ينتهى الباحث الي ان الفكر و الاجتهادات بالذات فالتراث الاسلامى تعبر عن متطلبات ايديولوجيه لطبقه او فئه اجتماعيه معينة. و الحقيقه _كما يرد _ تتجسد دائما، و فكل مكان، عن طريق الفاعلين الاجتماعيين، اي البشر، فهى شيء ملموس و محسوس. و يطرح المبادىء الاتية:1_ ليس هنالك من حقيقه غير الحقيقه التي تخص الكائن الانسانى المتفرد و المتشخص و المنخرط ضمن اوضاع محسوسه قابله للمعرفة.2_ ان الحقيقه موجهه لكى تعلن و تنشر ضمن و سط اجتماعى _ تاريخى يتنافس فية اناس مختلفون من اجل الوصول الي السلطه و السيطره عليها.3_ اذا كانت الحقيقه بكل اشكالها تتجسد دائما عن طريق و ساطه الانسان فعمل لا ينفصم من التعبير و الذكاء و الارادة، فانها تتطلب مستويات عديده من التحليل كاللغوى و التاريخى و السوسيولوجى و الانثروبولوجى و الفلسفي.يدعو اركون الي ما يسمية “الاسلاميات التطبيقية” التي تدرس الاسلام ضمن منظور المساهمه العامه لانجاز الانثروبولوجيا الدينية. و قام بعمليه اعاده قراءه القران (الفاتحة)، تخضعة ل “محك النقد التاريخى المقارن، و التحليل الالسنى التفككي، و التامل الفلسفى المتعلق بانتاج المعني و توسعاتة و تحولاتة و انهدامه”. رغم مساهمات الباحث المهنيه المهمة، الا ان مجالة يتركز اكثر علي الفكر او العقل او الوعى الاسلامي، فهو لا يهمل المجتمع و العلاقات الاجتماعيه تماما حيث يقول “انة يحاول فهم طريقة اختراق الدين و سطا اجتماعيا ما و مدي تمثلة فية او مدي نجاحة او فشله، بعدها العكس، اي مدي تاثير ذلك الوسط فالدين الرسمى و كيف يعدلة و يحور فية و يغيره”.ج_ الاخلاقيه الاقتصاديه للدينيعتبر ما كس فيبر الرائد الحقيقى لمبحث الاخلاقيه الاقتصاديةوالدين. و فتعريف للمصطلح يستبعد فالبدايه صله المفهوم بنظريات الاخلاق من منطلقها الدينى او اللاهوتى الصرف، و يقول ان المصطلح “يشير الي دوافع الفعل العمليه التي نجدها فالنسيج النفسى و العلمى _ البراغماتى للاديان. هنالك اشكال تنظيم اقتصادى معين تتفق مع اخلاقيات اقتصاديه محددة، و الاخلاق الاقتصاديه ليست مجرد و ظيفه تشكل تنظيما اقتصاديا، و ليس العكس (…) فو جة مواقف الانسان من العالم _ كما يحددها الدين او اي عامل داخلى _ للاخلاق الاقتصادية، و هو يركز فنظرته، علي فئات اجتماعيه معينه اثرت اكثر من غيرها فالاخلاق العمليه فاديانها، و علي الرغم من احتمال تغير الفئه تاريخيا، و لكنة يعنى _كما يقول _ بالفئات التي ربما يصبح اثر اسلوب حياتها اكثر و ضوحا فاديان معينة. و مهما كان و قع الاثار الاجتماعيه المحدده اقتصاديا و سياسيا فالاخلاق الدينيه فهى _بحسب فيبر _ تتخذ طابعها الاساسى من مصادر اسلامية، كالبشاره و الوعد. و كثيرا ما تعيد الاجيال تفسيرها بكيفية اصولية، و تعدل الاتهامات بحسب اشياء الجماعه الدينية. و يري ان القيم المقدسه هى فالواقع من هذة الدنيا كالصحه و الثروه و طول العمر، اما الزاهدون و المتصوفه فهم يتوقون الي قيم مقدسه فعالم اخر. و تتاثر القيم المقدسه بطبيعه المصالح و حياة الفئه الحاكمة، اي بالتراتب الاجتماعي.اشتهر فيبر بنظريتة عن دور البروتستانتيه فنشوء الراسمالية، و علي الرغم من انه لم يعط علاقه سببيه بينهما، فقد قصد ان يقول _بحسب نظريتة عن الفهم “ان الذهنيه البروتستانتيه كانت احد مصادر عقلنه الحياة التي ساهمت فتكوين ما يسمية الروح الراسمالية، و لم تكن الاسباب =الوحيد او الكافى للراسماليه نفسها”. و ياخذ علية البعض انه يوحى بان الحضاره الغربيه تتميز بذهنيه ذات درجه عاليه من العقلانية، هى التي انتجت ذلك النظام الاقتصادى بينما عجزت الاديان الاخرى، و من بينها الاسلام، عن ذلك. فقد يصبح الاسباب =ليس غياب العقلانيه عن تلك الاديان و لكنها بدت عاجزه عن ابتكار الادوات التقنيه و عن امتلاك الوسائل الروحانيه لتطور اكبر، و هو مطالب بتحديد سبب ذلك العجز. و العقلانيه مفهوم نسبي، و يرجع باحثون اخرون سبب تطور الراسماليه فالقرنين السادس عشر و السابع عشر بالذات فهولندا و انكلترا ليس الي القوي البروتستانتيه و لكن الي التحركات الاقتصاديه الكبرى، و بخاصه الكشوفات الجغرافيه و نتائجها.اما بالنسبه الي و ضع الاسلام ضمن العلاقه بين الاخلاق الاقتصاديه و الدين، فهنالك ملامح نظريه تنطبق علي جميع الاديان العالمية، و هى ان الوصايا الدينيه عن السلوك بالذات تلك الاكثر و اقعيه ربما يصبح لها اثر مباشر فالنشاطات الاقتصادية، كما ان المجموعات الدينيه ممكن ان توجة الدوافع و الاهتمامات الانسانيه نحو عدد من الاهداف ربما يصبح من بينها هدف اقتصادي، مثلا. من ناحيه الاختلاف بين الاسلام و البروتستانتيه بالذات، فقد اخطا فيبر حين تحدث عن اخلاقيه مقاتلين فالاسلام لونت رؤيه المسلمين للعالم. فقد عدل المحاربون _حسب فيبر _ تاويل الرساله المحمديه لتلبى اشياء حديثة هى فتح البلدان الاخرى. فالجهاد مبدا ديني، و لكنة و ضع فسياق تبريرى و تسويغ مختلف. و هو لا يرجع العجز العقلانى فالمجتمع الاسلامى الي سبب نفسيه بل الي البناء الذي ظهرت فية الدول الاسلاميه و الجماعات الاجتماعيه التي سادت. و الاسباب =الاخر المقابل لتفسير المحاربين للدين هو موقف الصوفيه الانسحابي، و فالحالتين يفتقد الاسلام الاخلاقيه المساعده فنشوء الراسمالية. و اثرت الاخلاق المقاتله فالمؤسسه السياسيه (نظام السلطنة) و فشكل المدينه (معسكر) التي ظلت تنتج اشياء الدوله فحسب _كل ذلك اثر فاحتمالات اي تطور اقتصادى _ اجتماعى عقلانى ربما يقود الي الراسمالية.
ومن الواضح غياب الصراع و التناقضات فالصوره التي قدمها فيبر عن المجتمعات الاسلاميه تاريخيا.هنالك محاوله موازيه لتحليلات فيبر للاسلام تسعي من زاويه مختلفه الي فهم العلاقه بين الاسلام و الاقتصاد، و يخرج داخلها نقد لفرضيات فيبر. يري رودنسون ان فيبر اخطا حين اعتبر ان الايديولوجيا الاسلاميه تتعارض مع العقلانيه اللازمه لنشوء الراسمالية، لان اسباب هذا ليس فالاسلام و لكن فالعوامل التي تكون اساس تلك الايديولوجيا “اى فجماع الحياة الاجتماعيه للعالم الاسلامي، و فالعقائد السابقة، بما فذلك المسيحيه فصيغتها الشرقية”.
ويري ان الاسلام لم يكن فجوهرة عقبه فسبيل نمو اخلاقيه تتجة نحو الراسمالية، و نجد الدليل فمجموعات كسكان الزاب فجنوب الجزائر المنتمين الي الشيعه الاباضيه التي تشبة فعديد من النواحى الكالفينيين، مؤسسى الراسماليه عند فيبر، لذا فالعله ليست فافكار جماعه ما و لكن فو ضعها الاجتماعي.
- دراسات دينيه
- ظاهرة دينيه
- ظواهر اجتماعية دينية
- ظواهر دينية
- ظواهر دينيه